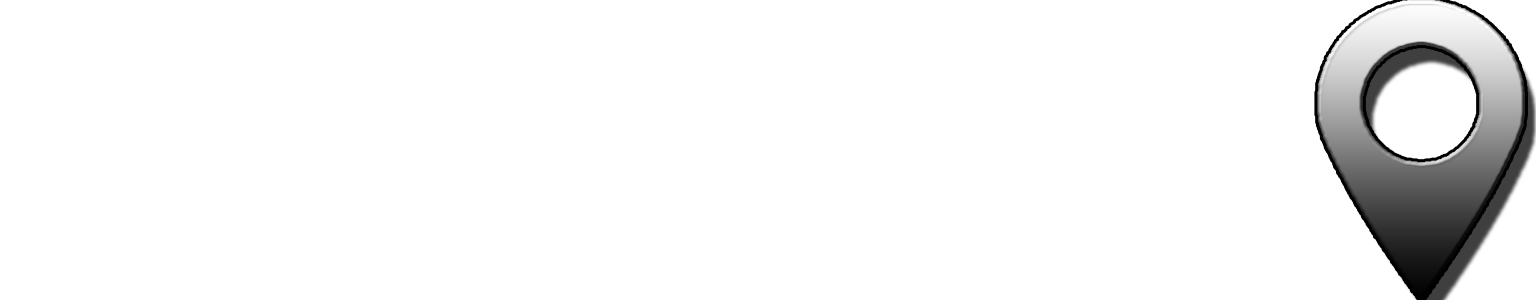طقوس عاشوراء في المغرب… بين التدين الشعبي، الفرح الجماعي، وخرافة الشعوذة
تحقيق الجهوية الجديدة
في المغرب، لا تأتي عاشوراء فقط كذكرى دينية تُخلّد حدثًا من التاريخ النبوي، بل تدخل حياة المغاربة كمناسبة اجتماعية وثقافية، مفعمة بالرموز والطقوس التي تتجاوز أبعادها الروحية لتلامس تفاصيل الحياة اليومية، وتُثير تساؤلات حول التدين الشعبي، الهوية الجماعية، وامتداد الخرافة.
يُعرف يوم عاشوراء دينيًا بأنه يوم صيام وصدقة وتذكّر لنجاة نبي الله موسى. لكن في المدن والأرياف المغربية، تأخذ المناسبة طابعًا احتفاليًا فريدًا. في ليلة التاسع من محرم، تشتعل النيران في الساحات الشعبية، ويقفز الأطفال حولها في طقس يُعرف بـ”الشعالة”. وفي الصباح، تُرشّ المياه في الشوارع فيما يُسمى بـ”زمزم”، ويُوزَّع ما يُعرف بـ”العشور” على الأطفال.
هذه المظاهر، وإن بدت عفوية، تساهم في تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، وتخلق نوعًا من الفرح الجماعي، خاصة في الأحياء الشعبية، حيث تُمثّل المناسبة فسحة للفرح المؤقت في واقعٍ صعب.
من زاوية علم الاجتماع، تُعد طقوس عاشوراء وسيلة من وسائل إعادة إنتاج الهوية الجماعية. فالاحتفال الجماعي، تبادل الهدايا، إشعال النار، وحتى استعمال الماء، كلها رموز تُساهم في تجديد العلاقات بين الأفراد، وتُكرّس الانتماء إلى الجماعة.
اللافت أن كثيرًا من هذه الممارسات لا ترتبط بالدين مباشرة، بل تنبع من موروث ثقافي طويل، حيث تمتزج فيه عناصر من التدين الإسلامي مع بقايا طقوس محلية ضاربة في القدم، استمرت بالتوارث جيلاً بعد جيل.
رغم الطبيعة الاحتفالية لعاشوراء، فإنها في بعض المناطق تُستغل أيضًا في ممارسات شعائرية غير دينية، ترتبط بما يُسمّى في المخيال الشعبي بـ”الروحانيات”. يتم خلال هذه الليلة جمع رماد “الشعالة”، أو ماء زمزم المزعوم، لاستخدامه في أغراض مرتبطة بالسحر أو التبّرك، سواء لجلب المحبة، فكّ النحس، أو الحماية من “التابعة”.
يرتبط ذلك بإيمان شعبي بأن عاشوراء ليلة “مفتوحة طاقيًا”، وأن الأعمال الروحية تكون فيها أكثر فعالية. وهي اعتقادات تُمثل، في عمقها، محاولة للتعامل مع القلق واللايقين في الواقع الاجتماعي، خصوصًا وسط النساء أو في الفئات الهشة.
تمثل النساء عنصرًا مركزيًا في طقوس عاشوراء، سواء من خلال دورهن في إشعال “الشعالة”، تنظيم الأنشطة المنزلية، أو حتى في ممارسة الشعوذة. تُتيح هذه الطقوس للمرأة مجالًا رمزيًا لتجاوز بعض القيود الاجتماعية مؤقتًا، من خلال الحضور في الفضاء العام، الغناء، التزيين، وتوجيه الأطفال والطقوس.
هذا الحضور لا يُمثّل تمرّدًا بقدر ما يعكس إعادة ترتيب مؤقتة للأدوار الاجتماعية داخل مناسبة ثقافية/دينية تحظى بالقبول المجتمعي.
عاشوراء تكشف، بشكل جلي، عن التداخل بين ما هو ديني وما هو ثقافي في الوعي المغربي. فبين الصيام المشروع، والطقوس التي لا أصل لها، تظهر ازدواجية في التديّن الشعبي: تدين قائم على الإيمان بالنص، وممارسات تستند إلى الرمز، البركة، والخوف من المجهول.
هذه الازدواجية لا تُفهم دائمًا على أنها جهل، بل تُعبر عن حاجة رمزية لإضفاء معنى على الحياة، وتثبيت نوع من الاستقرار النفسي والاجتماعي في مواجهة المجهول.
لإعادة الاعتبار للمضمون الحقيقي لعاشوراء، يُوصى بمجموعة من الخطوات: تعزيز التوعية حول القيم الروحية للمناسبة، مثل الصيام والإحسان والتسامح، وفصل ما هو ثقافي عن ما هو ديني، من خلال المدرسة والإعلام، وتجفيف منابع الشعوذة والخرافة التي تجد في هذه المناسبة فرصة للانتشار.
تُقدّم عاشوراء في المغرب نموذجًا مركبًا لمناسبة دينية أصبحت حاملة لمزيج من الرموز والتقاليد، بعضها أصيل وبعضها دخيل. وما بين النار والماء، الصيام والرماد، الهديّة والتعويذة… يظل السؤال مطروحًا: هل نعيش عاشوراء كذكرى للنجاة والتجديد، أم كطقس فلكلوري نتوارثه دون تمحيص؟