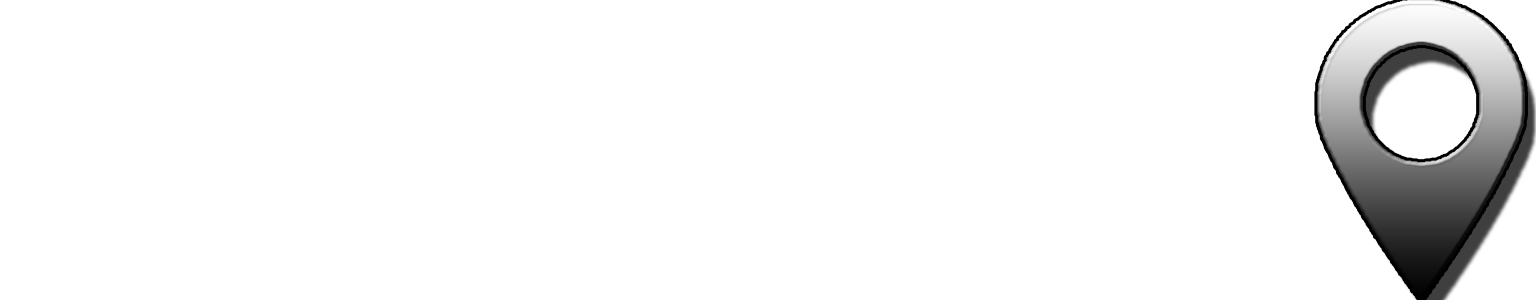التصوف… من الروحانية إلى ترسيخ الهوية المغاربية
تحقيق الجهوية الجديدة
صورة المقال من إبداع الفنان اجنياح عثمان
في وقت تشتد فيه النزاعات العقدية وتتصاعد التيارات المتشددة، يطفو على السطح من جديد الخطاب الصوفي باعتباره ملاذًا روحانيًا ومكوّنًا حضاريًا ساهم في بناء الشخصية الإسلامية والمغاربية، وأسس لتوازن ديني عابر للزمن.
من المغرب إلى تونس، ومن الأزهر إلى الجزيرة العربية، يثير التصوف مواقف متعددة تتراوح بين الاحتضان والانتقاد، بين التقديس والتشكيك. فهل التصوف اليوم مجرد تراث روحي؟ أم منظومة فكرية بديلة؟ وهل ما زال يحتفظ بقوته الرمزية في شمال إفريقيا؟
لم يكن التصوف في شمال إفريقيا دخيلًا، بل جاء متناسقًا مع طبيعة الإنسان المغاربي الميال إلى التدين المعتدل والروحي، ووجد له جذورًا في الزهد الأول، ليتحول لاحقًا إلى طرق منظمة لها زوايا وشيوخ وأتباع.
في المغرب، الجزائر، تونس وليبيا، انتشرت طرق مثل الشاذلية، القادرية، التيجانية، الدرقاوية وغيرها، مستندة إلى مرجعيات سنية وروحانية، دمجت بين الفقه والذكر، وارتبطت بالمجتمع عبر التعليم والعمل الخيري والوساطة الاجتماعية.
وقد لعب التصوف دورًا تاريخيًا كبيرًا في مقاومة الاستعمار، وتأطير الهوية الدينية، ونشر الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما جعله أكثر من مجرد “طريق روحي”، بل مشروعًا مجتمعيًا ووطنيًا.
في المغرب، يُعتبر التصوف مكونًا رئيسيًا ضمن الثوابت الدينية الثلاث: العقيدة الأشعرية، المذهب المالكي، والتصوف السني. وهو ما جعل المملكة تتبنى رسميًا خطابًا صوفيًا معتدلًا في سياستها الدينية داخليًا وخارجيًا، في مواجهة التطرف والغلو.
الزوايا المغربية مثل زاوية مولاي عبد السلام بن مشيش، البودشيشية، الدرقاوية، الوزانية وغيرها، كانت ولا تزال حاضرة بقوة في المشهد الديني والاجتماعي، وقد أنجبت علماء كبار جمعوا بين الفقه والسلوك الصوفي، مثل ابن عاشر، أحمد زروق، المهدي الفاسي.
في المغرب، لا يُنظر إلى التصوف كمجرد “تيار”، بل كمكوّن له امتداد سياسي وروحي، تجسده مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تستند بدورها إلى المشروعية الدينية التاريخية المرتبطة بالتصوف والزوايا.
في مصر، يختلف الخطاب، لكن يظل قريبًا من الطرح المغربي. علماء الأزهر عمومًا يُميزون بين التصوف الشرعي والتصوف المنحرف. ويؤكدون أن التصوف إذا كان على طريقة الجنيد والغزالي، فهو مظهر من مظاهر التدين الصحيح، لكنه إن انحرف نحو وحدة الوجود والغلو في الأولياء، وجب تصحيحه.
رموز مصرية مثل عبد الحليم محمود والشعراوي دافعوا عن التصوف، واعتبروه السبيل لتهذيب النفس وتقوية الإيمان، دون خروجه عن إطار العقيدة.
الأزهر نفسه، في كثير من مراحله، احتضن الطرق الصوفية، وأشرف على مواسم الأولياء كجزء من التقاليد الدينية والاجتماعية.
بالمقابل، يختلف الموقف جذريًا في المدرسة السلفية في الجزيرة العربية، خاصة منذ دعوة محمد بن عبد الوهاب، حيث يُعتبر التصوف – في معظمه – خروجًا عن التوحيد الصحيح.
علماء نجد والحجاز رفضوا بشدة مظاهر مثل التوسل، زيارة القبور، الذكر الجماعي، والطرق الصوفية، معتبرين أنها بدع محدثة، بل مدخلاً إلى الشرك في بعض حالاتها.
وفي الخطاب السلفي الكلاسيكي والمعاصر، يُنظر إلى التصوف كـ”انحراف عقدي”، ما لم يقتصر على الزهد الفردي والعبادة الخالصة دون تنظيمات أو رموز.
يبقى التصوف اليوم أمام تحديين كبيرين:
1. التحول إلى روح بلا مضمون، أي مجرد فولكلور لا يحمل مشروعًا دينيًا أو مجتمعيًا.
2. الهجوم من التيارات السلفية أو العلمانية، سواء بحجة البدعة أو فقدان الصلة بالعصر.
لكن في المقابل، يُراهن عليه كثيرون كرافعة لتجديد الخطاب الديني، وكمصدر لإسلام روحاني معتدل، قادر على احتواء التوترات، وتعزيز السلم الاجتماعي والروحي.
يظل التصوف، رغم كل الجدل، تجربة روحية إنسانية متجذرة في الوجدان الإسلامي. بين المغرب والأزهر، نلمس دعوة للتصوف المنضبط، وبين الجزيرة العربية، نسمع تحذيرًا من مخاطره.
لكن المغاربة، بخصوصيتهم الدينية، اختاروا منذ قرون أن يكون التصوف رافعة للهوية والاستقرار الروحي، لا مجرد تيار عابر.