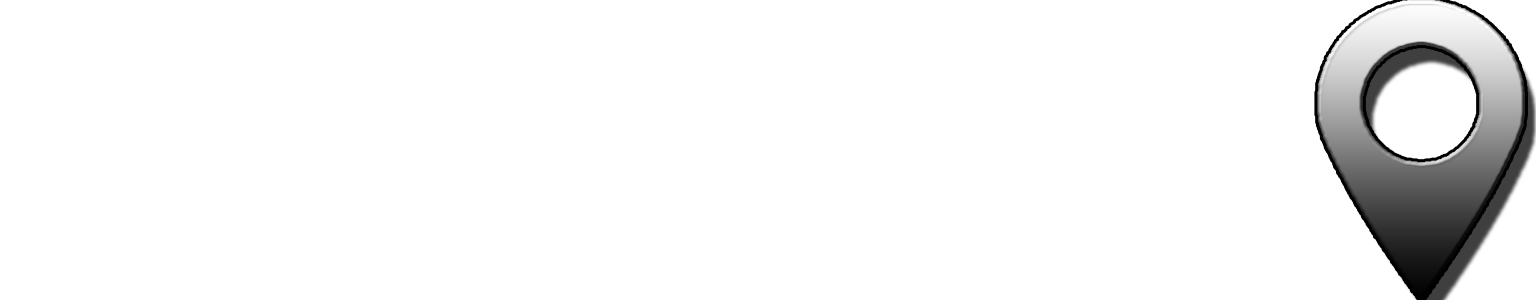في بلادنا العزيزة، حيث الشعب يتقن فن الاختزال، ويتمتع بحسّ بلاغي خارق، يكفي أن تتصرف امرأة بطريقة لا تروق لأحد ما، حتى يُطلق الحكم النهائي:
“شنو بغيتي من هاد شاطا ماطا؟”
نعم، ببساطة وبلا حاجة لشهادة في علم النفس أو دورة في الذكاء العاطفي، صار المجتمع يُشخّص الشخصيات، ويصنّف العقليات، ويوزع “الديبلومات الاجتماعية” بأحكام سريعة، وبلغة دارجة مرنة وقاتلة في آنٍ معًا.
“شاطا ماطا”؟ لا تبحث عنها في المعاجم، ولا في كتب علم الاجتماع. هي اختراع محلي 100%، مغربي حتى النخاع، لا يخضع لقواعد اللغة، بل لقوانين “النيّة المبيتة”.
في العمق، هي ليست مجرد عبارة فكاهية، بل وصف كامل متكامل لإنسان (غالبًا امرأة)، يُنظر إليه باعتباره: طائشًا، غير مسؤول، سريع الغضب، مزاجيًّا وربما، والكارثة الكبرى… حرًّا في تصرفاته!
نُطلقها على من تُعبّر عن رأيها، أو ترفض الخنوع، أو تلبس كما تشاء، أو تضحك بصوت مرتفع في مكان عمومي. أما الرجل؟ فهو – لسبب غير مفهوم – غالبًا “غير معني” بهذا التشخيص… إلا في حالات نادرة حين يتحول إلى “شوّاف” فايسبوكي أو محارب افتراضى متجول.
أنا شخصيًا التقيتُ نساءً وُصفت كل واحدة منهن بأنها “شاطا ماطا”. هل كنّ فعلاً كذلك؟ لا، كنّ فقط مختلفات. يرفضن قول “نعم” حين لا تعني “نعم”، لا يملكن صبر الصّامتات، ولا رغبة في لعب دور الضحية البريئة.
المشكل، طبعًا، ليس في العبارة ذاتها. فالشعب المغربي فنان في إنتاج “الكُودات” اللغوية. المشكل في ما تخفيه هذه العبارات من أحكام مسبقة، ومن ترسيخ لأدوار جندرية كلاسيكية: العاقلة = صامتة، المْربّية = تابعة، والمرأة الحرة = شاطا ماطا.
في زمن تُصنع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل الشخصية، نحن ما زلنا نحلّل الناس بجملة مثل:
“كتحس بيها كتفكر فشْكل، غير شاطا ماطا!”
ولا يسعني في ختام هذا المقال إلا أن أطرح السؤال الفلسفي الكبير:
هل نولد “شاطا ماطا” أم نصبح كذلك؟
وهل فعلاً “شاطا ماطا” صفة سلبية… أم مجرد تهمة جاهزة لمن يرفض القالب؟
سؤال أطرحه على القارئ، وعلى من لا يزال يعتقد أن المرأة الجريئة هي بالضرورة مشكلة وطنية.